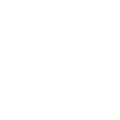الخطأ الطبي، بكل ما يحمله من تداعيات إنسانية وقانونية، يُعد من أكثر الموضوعات حساسية وتعقيدًا في المجتمعات المعاصرة. فهو يشكل نقطة تقاطع حادة بين المجال الطبي بمهنيته ومعاييره الدقيقة، وبين المجال القانوني بآلياته الرامية لتحقيق العدالة ورد الحقوق. في مصر، تُمثل قضايا الخطأ الطبي إشكالية قانونية بالغة الأهمية، نظرًا للحاجة الملحة لتحقيق توازن دقيق ومستدام بين عدة أهداف متشابكة، بل ومتنافسة أحيانًا:
-
حماية حقوق المرضى الأساسية: ضمان سلامتهم البدنية والنفسية، وصون كرامتهم، وتعويضهم تعويضًا عادلًا حال تعرضوا لأضرار ناتجة عن تقصير أو إهمال.
-
ضمان جودة الرعاية الصحية: الحفاظ على بيئة تمكن الأطباء والطواقم الطبية من تقديم أفضل رعاية ممكنة دون خوف مفرط أو شكوك دائمة.
-
حماية الممارس الطبي: منع إخضاع الأطباء لضغوط قانونية وعقابية غير مبررة قد تُثنيهم عن اتخاذ القرارات الجريئة الضرورية لإنقاذ الأرواح أو تجربة علاجات مبتكرة، أو قد تؤدي إلى ما يعرف بـ “الطب الدفاعي” (Defensive Medicine) الذي يركز على حماية الطبيب قانونًا أكثر من تركيزه على المصلحة العلاجية المثلى للمريض.
يسعى المشرع المصري جاهدًا، من خلال نصوص قانونية متعددة، لصياغة هذا التوازن الصعب. فهو من ناحية، يهدف لحماية المرضى من تبعات الخطأ الطبي الذي قد يعرض حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم الجسدية للخطر الجسيم أو الدائم. ومن ناحية أخرى، يسعى لتوفير إطار قانوني وآمن يطمئن فيه الأطباء لممارسة مهنتهم النبيلة بكفاءة واقتدار، مع العلم بأن القانون يميز بين الخطأ الطبي الناتج عن تقصير أو إهمال واضح، وبين المضاعفات الطبية غير المتوقعة أو الأخطاء غير المقصودة التي قد تقع رغم بذل أقصى درجات العناية والاحتراز. تحقيق هذا التوازن يتطلب نهجًا قانونيًا دقيقًا، مرنًا في تطبيقه، وصارمًا في مبادئه، لضمان تحقيق العدالة للطرفين معًا والحفاظ على ثقة المجتمع في المنظومة الصحية.
التعريف القانوني الدقيق للخطأ الطبي
يُعرِّف الفقه والقضاء المصري الخطأ الطبي تعريفًا يركز على عنصري الانحراف عن المعيار المهني ووجود الضرر. وبالتالي، فهو:
التقصير في بذل العناية الواجبة قانونًا والمهنيًا، أو المخالفة للأصول العلمية والفنية الطبية المتعارف عليها والمستقرة في مجال التخصص، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمريض.
هذا التعريف يشمل في طياته عدة عناصر جوهرية:
-
الفعل أو الامتناع: أي تصرف إيجابي (مثل إجراء جراحة بطريقة خاطئة) أو سلبي (مثل عدم تشخيص حالة طارئة) صادر عن الطبيب أو الفريق الطبي المسؤول.
-
الصلة بالمهنة: أن يقع هذا الفعل أو الامتناع أثناء أو بمناسبة مباشرة المهنة الطبية.
-
انحراف عن المعيار: أن يثبت أن التصرف انحرف عن مستوى العناية والحرص والمهارة التي كان سيبذلها طبيب “يقظ” و”متوسط الكفاءة” و”حريص” في نفس الظروف والمتخصص في نفس المجال.
-
الضرر: أن يترتب على هذا التصرف الخاطئ ضرر مادي (كالوفاة، العجز، زيادة المعاناة، تكاليف علاج إضافية) أو معنوي (كالألم النفسي، التشوه، فقدان فرصة الشفاء) للمريض.
-
علاقة السببية: أن يكون هناك رابطة سببية مباشرة بين الخطأ الطبي (التقصير أو المخالفة) وبين الضرر الذي لحق بالمريض. أي يجب إثبات أن الضرر ما كان ليحدث لولا ذلك الخطأ.
طبيعة التزام الطبيب: بذل العناية لا ضمان النتيجة
من المبادئ الراسخة في القانون الطبي المصري، والمستمدة من المادة 701 من القانون المدني، أن التزام الطبيب الأساسي تجاه مريضه هو التزام ببذل عناية (Obligation de moyens) وليس التزامًا بتحقيق نتيجة (Obligation de résultat). هذا التمييز بالغ الأهمية لفهم نطاق المسؤولية عن الخطأ الطبي.
-
التزام ببذل العناية: يعني أن الطبيب ملزم ببذل كل الجهد المطلوب، والحرص الواجب، والكفاءة المتوقعة من طبيب في تخصصه، مستخدمًا الأصول العلمية الثابتة والمعارف الطبية المتاحة، واتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة للمريض. لا يضمن الطبيب الشفاء التام أو نجاح العملية بنسبة 100%، فهو ليس ساحرًا، والطب علم احتمالي تحكمه عوامل كثيرة خارج إرادته.
-
الإخلال بالالتزام: تقوم المسؤولية عن الخطأ الطبي إذا ثبت أن الطبيب لم يبذل هذه العناية الواجبة، أو قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، أو خالف الأصول الطبية المعترف بها، مما أدى إلى ضرر للمريض. الفشل في تحقيق النتيجة المرجوة (كعدم شفاء المريض) لا يعني تلقائيًا وجود خطأ طبي، ما لم يقترن ذلك بتقصير في بذل العناية المطلوبة.
تصنيفات الخطأ الطبي: من حيث الجسامة والقصد
يمكن تصنيف الخطأ الطبي من زوايا مختلفة، أهمها:
أولاً: من حيث القصد أو النية:
-
الخطأ العمدي (المتعمد): وهو الأندر والأشد خطورة. يتحقق عندما يتعمد الطبيب الإخلال بواجبه القانوني والمهني بقصد إلحاق الضرر بالمريض. مثال: إجراء عملية غير ضرورية عن علم لتحقيق مكاسب مادية، أو حجب علاج أساسي بقصد الإضرار.
-
الخطأ غير العمدي (الإهمال والتقصير): هذا هو النوع الأكثر شيوعًا في قضايا الخطأ الطبي. ينشأ عن عدم بذل العناية الكافية، أو الغفلة، أو عدم الاحتراز، أو عدم اتباع الأصول الطبية، دون وجود قصد إلحاق الضرر. ينقسم بدوره إلى:
-
خطأ جسيم (إهمال جسيم): وهو خطأ فادح لا يقع فيه طبيب عادي يقظ وحريص في نفس الظروف. يكون واضحًا، صارخًا، ومثبتًا بشكل قاطع لا يحتمل الشك المعقول. مثال: نسيان أداة جراحية داخل جسم المريض، أو إجراء عملية على العضو الخطأ.
-
خطأ يسير (إهمال يسير): وهو خطأ أقل حدة، ولكنه مع ذلك يشكل إخلالًا بالعناية الواجبة. تبقى المسؤولية عن الخطأ الطبي اليسير قائمة إذا ثبت أنه سبب ضررًا للمريض، رغم بساطته النسبية. مثال: تأخير بسيط في إعطاء دواء، أو خطأ طفيف في جرعة دواء لم يترتب عليه ضرر كبير.
-
ثانيًا: من حيث مرحلة الخدمة الطبية:
-
خطأ في التشخيص (سوء تشخيص).
-
خطأ في اختيار العلاج أو تنفيذه.
-
خطأ في المتابعة أو الرعاية اللاحقة للعلاج أو الجراحة.
-
خطأ في التخدير.
-
خطأ في الحصول على الموافقة المستنيرة (سنأتي عليه لاحقًا).
ثالثًا: من حيث طبيعة الإجراء (علاجي مقابل تجميلي):
-
في الإجراءات العلاجية: يظل الالتزام الأساسي هو بذل العناية. لا يضمن الطبيب نتيجة الشفاء أو الشكل المثالي، بل يضمن اتباع المعايير.
-
في الإجراءات التجميلية البحتة: يميل القضاء غالبًا إلى تشديد المعيار، وقد يقترب من اعتباره التزامًا بتحقيق نتيجة إلى حد كبير، خاصة إذا وعد الطبيب بنتيجة محددة وجمالية واضحة. يتوقع المريض هنا تحسنًا جماليًا محددًا، وتخلف النتيجة المرجوة (مع توفر عناصر الخطأ الطبي في التنفيذ) قد يثير المسؤولية بسهولة أكبر.
المسؤولية القانونية: جنائية ومدنية
تترتب على الخطأ الطبي نوعان رئيسيان من المسؤولية القانونية:
1. المسؤولية الجنائية:
-
الأساس: تقوم عندما يتجاوز الخطأ الطبي حد الإهمال اليسير ليصل إلى درجة الإهمال الجسيم أو الخطأ الجسيم، ويتسبب في ضرر جسيم للمريض مثل الوفاة أو إحداث عاهة مستديمة أو مرض خطير.
-
النصوص القانونية: يعاقب عليها بموجب نصوص خاصة في قانون العقوبات:
-
المادة 238: “كل من تسبب بخطئه في موت شخص يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث، تكون العقوبة أشد”.
-
المادة 244: “كل من تسبب بإهماله في إصابة شخص بجروح أو مرض يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. وإذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، تكون العقوبة أشد”.
-
-
نية سليمة (سند الدفاع): المادة 60 من قانون العقوبات تنص: “لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة”. هذا يعني أن الطبيب قد يعفى من المسؤولية الجنائية إذا ثبت أن فعله (حتى لو أدى لضرر) كان مبنيًا على نية سليمة (العلاج)، وتوافرت فيه شروط “حق العلاج” وفق الأصول الطبية المعترف بها، ولم يصل خطؤه إلى درجة الجسامة التي تجعله خارج نطاق الممارسة المقبولة. الدفع بالنية السليمة هو دفاع موضوعي يخضع لتقدير المحكمة بناءً على ظروف كل حالة.
2. المسؤولية المدنية:
-
الأساس: تقوم بمجرد ثبوت الخطأ الطبي (يسيرًا كان أم جسيمًا) والضرر وعلاقة السببية بينهما، وتهدف إلى تعويض المريض (أو ورثته) عن الأضرار التي لحقت بهم.
-
نطاق التعويض: يشمل:
-
الأضرار المادية: مثل نفقات العلاج الإضافي، فقدان الدخل (الحالي والمستقبلي)، تكاليف الرعاية الخاصة، الأضرار بالممتلكات.
-
الأضرار المعنوية: مثل الألم النفسي والجسدي، التشوه، فقدان فرصة الشفاء، الانتقاص من الكرامة أو جودة الحياة.
-
-
النص القانوني: المادة 163 من القانون المدني المصري تنص صراحة: “كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.
-
طرف الدعوى: يرفعها المريض المتضرر أو ورثته ضد الطبيب أو المستشفى (المسؤولية التضامنية) أو كليهما.
جدول يلخص أنواع المسؤولية عن الخطأ الطبي في القانون المصري
| المعيار | المسؤولية الجنائية | المسؤولية المدنية |
|---|---|---|
| الهدف الأساسي | عقاب الجاني (الطبيب) وردع الآخرين. | تعويض المتضرر (المريض) عن الأضرار التي لحقت به. |
| الطرف الذي ترفع ضده | النيابة العامة (نيابة الأموال العامة أو نيابة الطب الشرعي) باسم المجتمع. | المريض المتضرر أو ورثته (دعوى شخصية). |
| نوع الخطأ المطلوب | خطأ جسيم (إهمال جسيم) غالبًا، وقد يكفي الإهمال في بعض الأحيان حسب جسامة النتيجة. | أي خطأ طبي (يسير أو جسيم) يسبب ضررًا. |
| الضرر المطلوب | ضرر جسيم (الوفاة، عاهة مستديمة، مرض خطير). | أي ضرر مادي أو معنوي يثبت سببه للخطأ. |
| العقوبة / الجزاء | عقوبات سالبة للحرية (حبس) و/أو غرامات تدفع للخزينة العامة. | تعويض نقدي (أو عيني نادرًا) يُدفع للمتضرر أو ورثته. |
| الإثبات | إثبات كامل (يقين قضائي) يفيد الجاني بما لا يدع مجالاً للشك المعقول. | إثبات بدرجة عالية من الاحتمال (الاطمئنان القضائي) غالبًا. |
| الأساس القانوني | قانون العقوبات (مواد 238، 244، 60). | القانون المدني (مواد 163، 178، 221)، مبادئ المسؤولية التقصيرية. |
| إمكانية العفو/التسامح | لا يسقط الحق العام بالعفو الخاص أو تنازل المجني عليه (إلا في جرائم الجنايات التلبسية). | يمكن التنازل عن الدعوى المدنية أو الصلح بين الأطراف. |
الإطار التنظيمي: نقابة الأطباء وقانون المهن الطبية
يضبط مزاولة مهنة الطب في مصر قانونان رئيسيان:
-
قانون تنظيم المهن الطبية (رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته): يحدد هذا القانون شروط مزاولة المهنة، وواجبات الأطباء، وحقوقهم، والحدود الأخلاقية والمهنية لممارستهم. ويضع المعايير الأساسية للرعاية الطبية التي تشكل المرجعية لتقييم وجود الخطأ الطبي من عدمه.
-
قانون نقابة الأطباء (رقم 74 لسنة 1969 وتعديلاته): ينظم عمل النقابة كجهة رقابية وأخلاقية على أعضائها. وتلعب النقابة دورًا محوريًا في قضايا الخطأ الطبي من خلال:
-
لجان التحقيق الطبي (المادة 46): تُشكل هذه اللجان (غالبًا من أساتذة متخصصين) للتحقيق في الشكاوى المقدمة من المرضى ضد الأطباء. مهمتها الفنية هي تقييم التصرف الطبي المطعون فيه ومدى انحرافه عن الأصول العلمية والمهنية، وتحديد ما إذا كان يشكل خطأ طبيًا أم لا، ودرجة جسامته.
-
تحديد العقوبات النقابية: في حال ثبوت الخطأ الطبي، تفرض النقابة عقوبات على الطبيب تتراوح من الإنذار والتوبيخ، إلى الوقف عن العمل لمدة محددة، أو الشطب من جدول النقابة (منع من الممارسة) في الحالات بالغة الجسامة. هذه العقوبات مستقلة عن العقوبات الجنائية أو المدنية التي قد يحكم بها القضاء.
-
الموافقة المستنيرة: حجر الزاوية في العلاقة الطبية
يُعد الحصول على “الموافقة المستنيرة” (Informed Consent) من المريض قبل أي إجراء طبي جوهري (وخاصة الجراحات) شرطًا أساسيًا وأخلاقيًا وقانونيًا. غيابها أو عدم صحتها قد يشكل في حد ذاته خطأ طبيًا يترتب عليه المسؤولية، حتى لو كان الإجراء ناجحًا. تشمل الموافقة المستنيرة:
-
التوضيح الكامل: شرح طبيعة المرض، الإجراء الطبي أو الجراحي المقترح، فوائده، مخاطره المحتملة (بما في ذلك المخاطر النادرة والخطيرة)، البدائل المتاحة (إن وجدت) ومخاطرها، ومخاطر عدم القيام بأي إجراء.
-
الاستيعاب: التأكد من فهم المريض (أو وليه) لكل المعلومات المقدمة له.
-
الاختيار الحر: اتخاذ المريض لقراره بحرية تامة دون ضغط أو إكراه.
-
التوثيق: تسجيل عملية الإفادة وموافقة المريض كتابيًا في ملفه الطبي (نموذج موافقة).
التمييز بين الإجراءات العلاجية والتجميلية في الموافقة والمسؤولية
-
الإجراءات العلاجية: الهدف هو علاج مرض أو خلل وظيفي أو إنقاذ حياة. الموافقة المستنيرة هنا تركز على شرح طبيعة المرض، ضرورة الإجراء، مخاطره في سياق الحالة المرضية، والبدائل. المسؤولية عن الخطأ الطبي تُقاس بمعيار بذل العناية في التشخيص والعلاج حسب الأصول.
-
الإجراءات التجميلية البحتة: الهدف هو تحسين المظهر الخارجي بناءً على رغبة المريض الشخصية. الموافقة المستنيرة هنا يجب أن تكون أكثر تفصيلاً وتحديدًا للنتائج المتوقعة (مع إيضاح حدود الإمكانيات) والمخاطر. المسؤولية عن الخطأ الطبي هنا قد تقترب أكثر من ضمان تحقيق النتيجة الجمالية الموعودة أو المتوقعة ضمن الحدود المعقولة، خاصة إذا وُجدت وعود مبالغ فيها أو سوء تنفيذ واضح.
إثبات الخطأ الطبي: دور القضاء والخبرة الطبية
إثبات الخطأ الطبي في المحكمة يقع عبئه الأكبر على عاتق المريض المدعي (أو النيابة العامة في الدعوى الجنائية). يواجه المدعي تحديات كبيرة تتمثل في:
-
الطبيعة الفنية المتخصصة: يحتاج القاضي، غير المتخصص في الطب، إلى أدلة فنية قاطعة.
-
الوصول إلى المعلومات: صعوبة الحصول على الملف الطبي الكامل أحيانًا.
-
تحديد المعيار المهني: ما هي الأصول الطبية “المتعارف عليها” في هذه الحالة بالذات؟
هنا يأتي الدور المحوري للخبرة الطبية:
-
تعيين الخبراء: يقوم القاضي (أو النيابة) بتعيين لجنة أو خبير طبي محايد (غالبًا من أساتذة الطب) لتقديم تقرير فني.
-
مهمة الخبراء: دراسة كافة المستندات (الملف الطبي، محضر التحقيق النقابي إن وجد، شهادة الأطراف)، وتحليل التصرف الطبي المطعون فيه.
-
المعيار المرجعي: تقييم ما إذا كان الطبيب قد تصرف وفقًا لمستوى العناية والمهارة المتوقع من طبيب “متوسط الكفاءة” و”يقظ” في نفس التخصص وبنفس الظروف، ومدى انحراف تصرفه عن الأصول العلمية والفنية المستقرة.
-
الرأي الفني: يقدم الخبراء رأيًا مفصلًا يبين وجود الخطأ الطبي من عدمه، ونوعه (جسيم/يسير)، ومدى علاقته السببية بالضرر الواقع، وأحيانًا نسبة العجز أو الضرر. هذا الرأي ليس ملزمًا للقاضي، لكنه يشكل دليلًا فنيًا قويًا يعتمد عليه بشكل كبير في تكوين اقتناعه.
معايير التقييم في مراحل الممارسة المختلفة
يتم تقييم سلوك الطبيب في كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة:
-
التشخيص:
-
هل أخذ التاريخ المرضي بدقة؟
-
هل أجرى الفحص الإكلينيكي اللازم؟
-
هل طلب الفحوصات المعملية والإشعاعية المناسبة والمطلوبة للتشخيص التفريقي؟
-
هل استعان بآراء متخصصين عند الحاجة؟
-
هل وصل للتشخيص الصحيح بناءً على المعلومات المتاحة، أو هل كان تشخيصه خطأً ناتجًا عن إهمال واضح في اتباع الخطوات التشخيصية المعتادة؟
-
-
العلاج (الدوائي أو الجراحي):
-
هل اختيار العلاج كان مناسبًا للتشخيص ووفقًا للمعايير؟
-
هل تم شرح خيارات العلاج ومخاطرها للمريض؟
-
في الجراحة: هل تم التحضير الجيد (فحوصات ما قبل الجراحة، التخدير المناسب)؟
-
هل تم تنفيذ الإجراء الجراحي وفق الأصول الفنية المعترف بها؟
-
هل تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع المضاعفات (مثل التعقيم، التحكم في النزيف)؟
-
هل كانت هناك أخطاء في الجرعات الدوائية أو طرق إعطائها؟
-

-
المتابعة والرعاية اللاحقة:
-
هل تم متابعة حالة المريض بعد الإجراء أو الجراحة بشكل كافٍ؟
-
هل تم تشخيص المضاعفات مبكرًا والتعامل معها بشكل مناسب؟
-
هل تم إعطاء التعليمات اللازمة للمريض بعد الخروج؟
-
-
التخدير:
-
هل تم تقييم حالة المريض قبل التخدير بشكل كامل؟
-
هل اختيار نوع التخدير كان مناسبًا؟
-
هل تم مراقبة المريض بشكل مستمر ومكثف أثناء التخدير؟
-
هل تم التعامل مع مضاعفات التخدير بسرعة وكفاءة؟
-
أمثلة تطبيقية لقضية الخطأ الطبي (للاسترشاد):
-
خطأ في التشخيص: طبيب يهمل أعراضًا واضحة لالتهاب الزائدة الدودية الحاد عند طفل، مما يؤدي لانفجارها وإصابته بالتهاب الصفاق.
-
خطأ في العلاج: جراح يستخدم تقنية جراحية غير معتمدة أو خطيرة لعلاج حالة بسيطة كان يمكن علاجها بطريقة أقل خطورة، مما يؤدي لمضاعفات.
-
خطأ في التخدير: طبيب تخدير لا يتحقق من تاريخ حساسية المريض لدواء معين، أو لا يراقب العلامات الحيوية بشكل كافٍ أثناء الجراحة.
-
خطأ في المتابعة: عدم اكتشاف نزيف داخلي بعد عملية جراحية رغم وجود علامات واضحة، مما يؤدي لتفاقم الحالة.
-
خطأ في الحصول على الموافقة: إجراء عملية تجميلية دون شرح كافٍ للمخاطر المحتملة (مثل فقدان حاسة الشم في عملية تجميل الأنف).
-
الإهمال الجسيم: إجراء عملية على العضو الخطأ (كاليد اليسرى بدلًا من اليمنى)، أو نسيان مشبك أو قطعة شاش داخل تجويف البطن بعد الجراحة.
الخاتقة: السعي الدائم نحو التوازن والعدالة في قضايا الخطأ الطبي
يبقى الخطأ الطبي في القانون المصري قضية إنسانية وقانونية بالغة التعقيد، تتطلب فهماً دقيقاً لطبيعة الممارسة الطبية المحفوفة بالمخاطر والمجهول أحياناً، واحتراماً لحقوق المرضى في الحصول على رعاية آمنة والانتصاف حال تعرضهم للضرر بسبب تقصير. المعايير القانونية التي تم استعراضها – من تعريف الخطأ الطبي، وطبيعة التزام الطبيب، وتصنيفات الخطأ، وأنواع المسؤولية (جنائية ومدنية)، ودور النقابة والموافقة المستنيرة، وأهمية الخبرة الطبية – تشكل معًا نسيجًا قانونيًا يحاول التوفيق بين هذه الأهداف المتعددة.
التطبيق الصارم والعادل لهذه المعايير، مع الاعتماد على الخبرة الطبية الموضوعية، هو الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة لكل من المريض المتضرر والطبيب الملتزم بمعايير مهنته. إنه توازن دقيق، لكنه ضروري لاستمرار ثقة المجتمع في مهنة الطب، ولضمان تقدم الرعاية الصحية في مصر مع حماية الحقوق الأساسية للأفراد. الوعي بهذه الحقوق والواجبات من قبل المرضى والأطباء على حد سواء، والشفافية في التعامل مع حوادث الخطأ الطبي، والتحسين المستمر للأنظمة والبروتوكولات الطبية، هي جميعًا عناصر حيوية في تقليل فرص وقوع الأخطاء ومعالجتها بشكل عادل وفعال حين تحدث